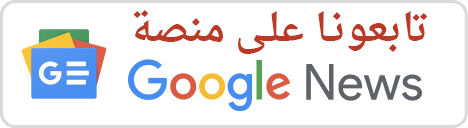حوار بين العقل والنص: تأملات في قضايا المرأة بين شحرور والقرضاوي
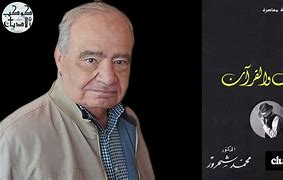
في فضاء الفكر الإسلامي الرحب، لطالما دار الحوار بين من يلتزم الفهم الموروث للنصوص، ومن يسعى إلى تجديد قراءتها بما يتلاءم مع تطورات العصر. في قلب هذا الجدل، برز مفكران كبيران، اختلفا في المنهج واتفقا على خدمة الإسلام كل بطريقته:

الدكتور يوسف القرضاوي (1926 – 2022)، العالم الأزهري الذي سعى إلى التوفيق بين الشريعة ومقتضيات الواقع، وصاحب كتاب “الحلال والحرام في الإسلام” الذي صدر عام 1960.
والدكتور محمد شحرور (1938 – 2019)، المهندس والمفكر السوري، الذي خاض معركة التأويل الجديد للنص القرآني، بدايةً مع كتابه “الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة” عام 1990، ثم توالت كتبه، أبرزها “المرأة والوصية” عام 1999، حيث تناول فيه قضايا المرأة والإرث بلغة عقلانية تفكيكية.
يجتمعان هنا في حوار افتراضي راقٍ حول واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الفكر الإسلامي المعاصر: المرأة بين الحجاب والإرث، حيث تتجلى التباينات الفكرية بعمق.
يوسف القرضاوي: أخي محمد، في كتابي “الحلال والحرام في الإسلام” الذي صدر عام 1960، أوضحت أن الحجاب ليس عادةً اجتماعية، بل فريضة شرعية ثابتة بنصوص قطعية. الآية: “يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن…” [الأحزاب: 59]، واضحة في بيان وجوب الحجاب، وقد أجمع عليه جمهور العلماء، وهو جزء من أخلاق الإسلام.

محمد شحرور: شيخنا الكريم، في أول أعمالي “الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة” سنة 1990، ثم لاحقًا في “المرأة والوصية” عام 1999، سعيت لتفكيك المفاهيم السائدة بناءً على دراسة لغوية ومعرفية للنص. لم يرد في القرآن أي تشريع صريح بزي موحد للمرأة. الحجاب، كما نعرفه اليوم، هو ثمرة فقه تاريخي لا نص قرآني مباشر. المطلوب من المرأة في القرآن هو “الستر” وليس “الزي المفروض”.
القرضاوي: لكنك بهذا تتجاوز النصوص، فالتفسير ليس خاضعًا للذوق أو المزاج. نحن نحتكم إلى ما قاله النبي وما أجمع عليه السلف، لا إلى السياق المتغير فقط. الحجاب عبادة، لا يمكن إخضاعها لعُرف العصر.
شحرور: لا أتجاوز النص، بل أعود إليه. الآيات القرآنية لم تتحدث عن “الحجاب” كمفهوم فقهي، بل عن مفاهيم مثل “الجلابيب” و”الخمار” و”الستر”، وهي مصطلحات تاريخية مرتبطة بالبيئة والمجتمع. لا يمكن أن نُلزم نساء القرن الحادي والعشرين بما فُهم في القرن الأول الهجري.
القرضاوي: نفس المسألة نجدها في الإرث. الآية “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين…” [النساء: 11] جاءت بصيغة قاطعة. لا اجتهاد مع النص. الإسلام حدّد حصص الإرث بدقة لحماية الحقوق.
شحرور: لكن في “المرأة والوصية” (1999)، قرأت هذه الآية ضمن سياقها: الآيات تبدأ بكلمة “الوصية”، وهي مفهوم مختلف عن “الفرائض”. الوصية كانت الأصل قبل أن ينظّم الفقهاء الميراث لاحقًا. ولذا يمكن – بحسب الواقع الجديد – أن تكون المساواة ممكنة بين الرجل والمرأة، خاصة حين تتساوى الأعباء والمسؤوليات.
القرضاوي: هذا الطرح فيه خطر عظيم. أنت بذلك تمهد لنقض أصول الشريعة. نحن نحتاج إلى التجديد نعم، ولكن التجديد داخل الإطار، لا بإعادة تفسير كل ثابت وفق أهواء العصر.
شحرور: بل أنا أطرح قراءة عقلانية تحترم النص وتعيد له الحياة. النص القرآني غني ومرن، ولكننا قيدناه بمنظومة فقهية أُنتجت في ظروف لا تشبه واقعنا. الإصلاح الحقيقي يبدأ من قراءة جديدة للنص، لا من تكرار ما قاله السابقون.
انتهى الحوار دون حسم، كما هو شأن الحوارات الكبرى. بين قراءة تقليدية ترى في الثوابت صمّام أمان للأمة، وقراءة عقلانية ترى أن الجمود على الفقه القديم هو ما يعطل حركة الدين في العصر، تبقى الأسئلة مفتوحة، وتبقى الحاجة إلى حوار مستمر.
فكلا الرجلين، القرضاوي وشحرور ، أسهما في إغناء الفكر الإسلامي، كلٌّ من زاويته، فكان الأول صوتًا للوسطية المؤصلة، والثاني دعوة للقراءة الجريئة المتجددة.
ايمان وليب