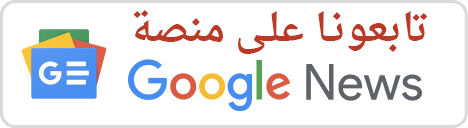العنف الرمزي، والمؤسسات الأربع الكبرى: المدرسة والإعلام والصحافة والدين
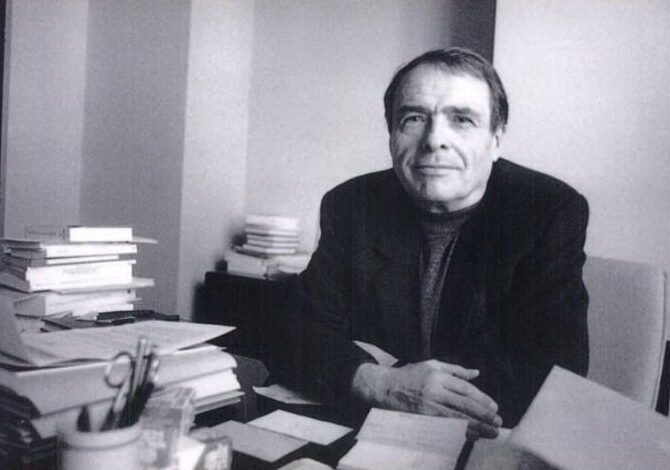
المدرسة والإعلام والصحافة والدين هي أربع مؤسسات كبرى داخل المجتمع، تكاد تكون هي المجتمع بل إن المجتمع مشكل من خلالها؛ لذا علينا أن نعي دورها وأن نكون على دراية بتأثيرها الذي يتطلب حضورنا بوعي خصوصا من موقعنا وتفاعلنا وفق الجهة أو المسؤولية التي ننتمي إليها (مربين أو موجهين أو أولياء الأمور أو ممثلي المجتمع المدني أومدبري الشأن العام المحلي أو الجهوي أو الوطني، أو ضمير المجتمع من نقاد وإعلاميين وغيره، بالأساس كمواطنين مشاركين فاعلين) هذه المؤسسات التي من أهم مهامها، التدبيرية والتسييرية بل والقيادية للمجتمع من موقع القوة الاقتراحية والنقدية تعزيزا للحوار المجتمعي الذي يضبط المفاهيم التي تتشكل بها ديناميته وتفاعله، بهذا الرباعي تمارس الدولة نوعًا من العنف الرمزي الذي تحتكره لوحدها وفق الدستور تشريعا وقانونا من خلال مؤسساتها الرسمية المباشرة وغير المباشرة ومنها المؤسسات التي وكلت لها المهام القيادية والرقابية تم المؤسسات التوجيهية وأخرى الإعدادية للمواطن الرسمي.
نبدأ من المدرسة والجامعة، المختبر الذي يعد لنا هذا المواطن الرسمي والموظف الرسمي والمسؤول الرسمي بل حتى الفنان والإعلامي الرسميين، وصولا إلى رجل الدين الرسمي، وفق المفهوم الجديد الذي تبني عليه الدولة تذبير مهامها الذي تنخرط فيه كل المؤسسات العامة والخاصة، بأيديولوجية وسلطة تدبيرية متحكمة، حيث تفرض هذه المدرسة والجامعة وحتى المسيد نوعا من القيم والمعايير الاجتماعية على التلاميذ والطلبة وفق فرضية الشيخ والمريد، كما يتم تحديد للمدبر والمسير شأنه ما هو مقبول وما هو غير مقبول وفق قوانين وضعية تمثل جهة نظر واحدة.
في خضم هذه التدبير المجتمعي الرسمي، تبرز سلطة الإعلام الرسمي الذي له مهمة تشكيل الرأي العام من خلال تقديم معلومات محددة، في زمن محدد، لفئة محددة، تكاد تكون معلبة، وتمارس تدبير قضايا المواطنين من وجهة نظر أحادية مع احتكار سوق التأثير على مواقف الناس وآرائهم، كما يمكن أن يؤدي هذا الإعلام الموجه إلى ترويج قيم ومعايير اجتماعية المحددة مملاة حتى على الدولة من الجهات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق البنك الدولي، الذي يقود الإصلاحات الكبرى في جميع الدول خصوصا دول العالم الثالث.
وهي نفس مهمة الصحافة عموما حينما تكون بيد الدولة، التي توظفها كمهام خبرية وكإيديولوجية تم كرشوة أو شراء الدمة من خلال سياسة الدعم العمومي والمرفق العمومي ومنها تدبير الشأن الإشهاري وباقي الامتيازات، وتقدم مهمة تقديم الأخبار والمعلومات بطريقة محددة ولها هي الأخرى مهمة التأثير على الرأي العام من خلال تقديم وجهات نظر معينة تفرضها وبقوة الطرح وزمنه، الأمر الذي يهمش الأطروحة المخالفة إما بالتضليل أو الاهمال، وأحيانا كثيرة الإلغاء.
وهي نفس مهام الرئيسية للمؤسسة الدينية التي تمارس تقديم القيم والمعايير الاجتماعية من خلال التعاليم الدينية والتأثير على مواقف الناس وآرائهم بالفتوى وسياسة الاجماع، وبذلك تحمي من يتماشى معها وتلغي الآخر المخالف لها ومن له معتقدات أخرى بل الأمر يمارس داخل نفس الديانة التي لها تيارات متنوعة، حيث لا تقبل التعددية وتصادر الحريات، خصوصا التي تستعمل الفكرة والعقل النقدي.
من هنا يتولد العنف الرمزي بتعدد مناحيه والذي تلجأ إليه كل هذه المؤسسات الأربع الكبرى بشرعنة الدولة، حيث تباشر هذه المؤسسات الأربع تأثيرها على المجتمع الذي يتعدد ممثليه ومخالفين ومريديه وحتى معارضيه.
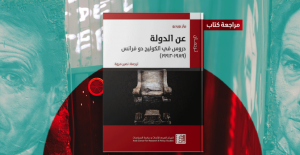
هذا ما يبرر ما استنتجه بيير بورديو عن كتابه ” العنف الرمزي” ويصف هذا النوع من العنف، كونه: “هو عبارة عن عنف لطيف، وغير محسوس، وهو غير مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم، وهو عنف يمارس عبر الطرائق والوسائل الرمزية الخالصة، أي: عبر التواصل، وتلقين المعرفة، وعلى وجه الخصوص عبر عملية التعرف والاعتراف” وحسب بيير بورديو، فالعنف الرمزي “هو أيضاً صنوف من التصرفات والأقوال والأفعال والحركات والكتابات، التي من شأنها أن تـُلحق الأذى بالاتزان النفسي أو الجسدي لشخص ما، وأن تـُعرّض عمله وحياته للخطر، وأن تتسبّب بتعكير مناخ العمل وتسميمه” وأضاف “يمكن تعريفه: هو نوع من العنف الثقافي الذي يؤدي وظائف اجتماعية كبرى، ويمكن تلمسه في وضعية الهيمنة التي يمارسها أصحاب النفوذ على أتباعهم بصورة مقنّعة وخادعة، إذ يقومون بفرض مرجعياتهم الأخلاقية والفكرية على الآخرين من أتباعهم، ويولدون لديهم إحساسا عميقا بالدونية والعطالة والشعور بالنقص”
أحمد طنيش