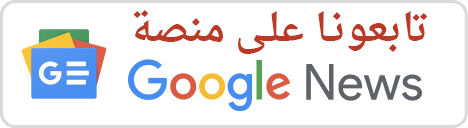لحظة مع كتاب: مفهوم الحرية ومفهوم الدولة، للمفكر المغربي عبد الله العروى
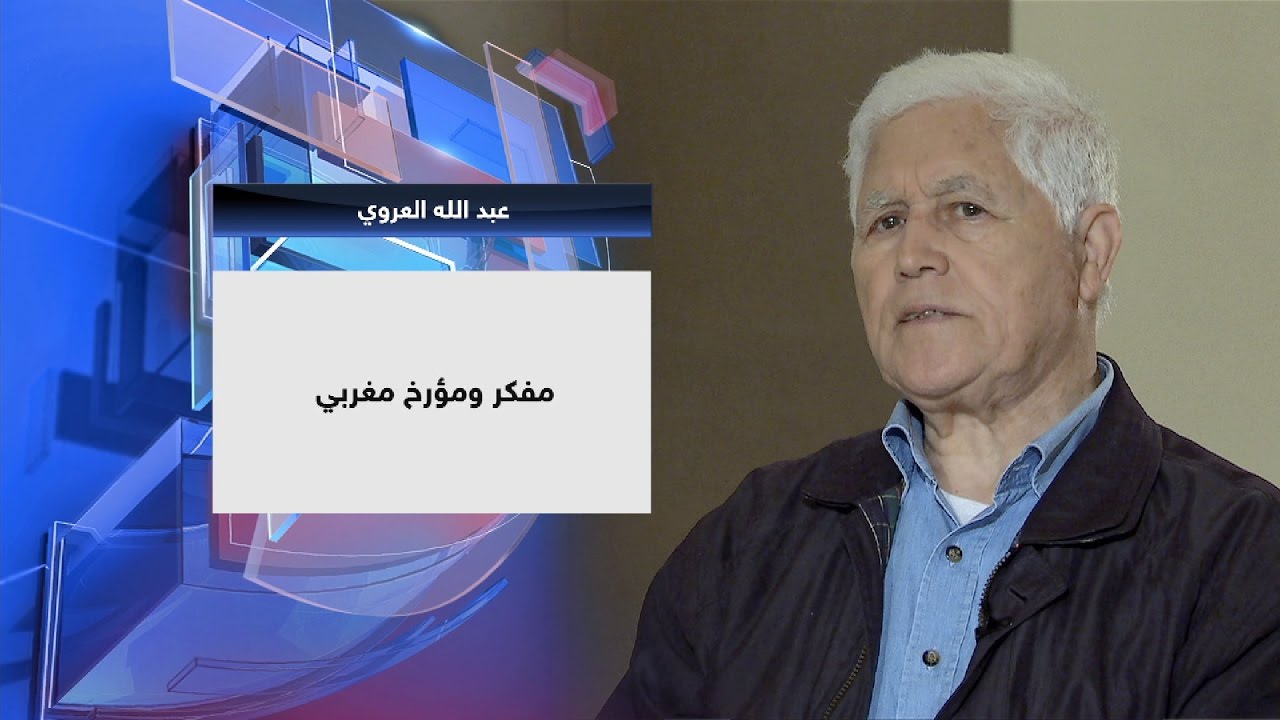
يعد مفهوم الحرية من أبلغ المفاهيم الإنسانية تداولا، بين الثقافي والمعرفي والعلمي الخاص منه والعام، شخصيا حينما يطرح علي هذا المفهوم أعود إلى المفكر المغربي عبد الله العروي خصوصا في سلسلة مفاهيم ومنها كتابه القيم” مفهوم الحرية” الصادر عن دار النشر المركز الثقافي العربي، الطبعة الخامسة، 1993. لما يحوزه هذا الكتاب من أهمية معرفية في الساحة الفكرية المغربية والعربية على حد سواء. رصد العروي تحليله لمفهوم الحرية وفق أربع مستويات معرفية؛ أولها معنون بـ” طوبي الحرية في المجتمع الإسلامي التقليدي” حيث عالج فيه مسألة الحرية استنادا على المنظومة المعجمية العربية، وفند مفهوم الحرية في اللسان العربي الحديث التي لا تعدو أن تكون ترجمة اصطلاحية لكلمة أروبية تستعير منها كل معانيها العصرية بدون أدنى ارتباط بجذورها العربية، يؤكد بذلك أن مفهوم الحرية مأخوذ من الثقافة الغربية ، حيث لا وجود له في الثقافة العربية الإسلامية التقليدية لكون ممارسة الحرية حسب العروي منعدمة في المجتمع الإسلامي التقليدي، حيث لم نجد مفهوم في الثقافة و لا الكلمة بمعناها العصري المحدد في القاموس.

ركز العروي على أربع مصطلحات تضممن مفهوم الحرية: البداوة، التصوف، العشيرة، التقوى. في حين جاء الفصل الثاني، الموسوم بـ ” الدعوة إلى الحرية (عهد التنظيمات)” موضحا فيه ما يصطلح عليه سياسات الإصلاح كامتداد لتوغل أنظمة الدولة و إقحام الفرد في تجربة السياسة، وارتباط مفهوم الحرية بالدولة، وأشار هنا إلى أن المجتمع العربي الإسلامي قبل القرن 18 كان يعرف نوعا من التوازن إن صح التعبير بين أربع مكونات : البداوة باعتبارها الأصل، والعشيرة التي تحافظ على حرية التصرف، ثم الدولة كمقابل لهذين المكونين، و الفرد كان يناهضها – أي الدولة – من وراء المكونات الأولى – البداوة و العشيرة- لكن هذا المنطق عرف تغيرا كبيرا، ناتجا عن التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع العربي الإسلامي بشكل عام . هذا التغيير الذي سمي بالإصلاح أو سياسة التنظيمات والذي عمد على تقوية هياكل الدولة مقابل إضعاف الجماعات و الأفراد و إدماجهم بأي طريقة تحث كنف الدولة وأجهزتها، لكي لا تتصل بالعدو الاستعماري.
وخلص العروي في الفصل الثالث إلى ضبط مفهوم “الحرية اللبرالية “ والتي تضمن تحديد معالم التفكير اللبرالي، و تبيان الأشواط التي خاضها عبر ( أربع مراحل) ليلتقي بها المفكر العربي على شكل منظومة فكرية متناقضة.
“مرحلة التكوين؛ حيث كانت وجها من وجوه الفلسفة الغربية المرتكزة على مفهوم الفرد و مفهوم الذات ( مفهوم الذات الفاعلة و صاحبة الاختيار و المبادرة ).
مرحلة الاكتمال؛ حيث كانت الأساس الذي شيد عليه علمان عصريان مهمان : علم الاقتصاد و علم السياسة النظرية ( مفهوم الفرد العاقل و المالك لحياته و بدنه و ذهنه وعمله ).
مرحلة الاستقلال؛ حيث نزعت اللبرالية من أصولها كل فكرة تنتمي إلى الاتجاه الديمقراطي بعد أن أظهرت تجربة الثورة الفرنسية أن بعض أصول اللبرالية قد تنقلب عند التطبيق إلى عناصر معادية لها( مفهوم المبادرة الخلاقة الذي هي نتاج الفرد الخلاق عكس الفرد العاقل ).
مرحلة التقوقع؛ حيث أصبحت تعتبر أنها محاطة بالأخطار وأن تحقيقها صعب إن لم يكن مستحيلا، لما تستلزم من مسبقات غير متوفرة لدى البشر في غالب الحيان ( المغايرة و الاعتراض، لأن الاختلاف هو أساس الجدل و الجدل أساس التقدم، عكس مسايرة الآراء الغالبة).
وبهذا وصلنا مع العروي إلى الفصل الرابع : ” نظرية الحرية”، حاول فيه عبد الله العروي أن يجادل في كل من الفكر اللبرالي والماركسي والوجودي، و تصورهم الفلسفي لمفهوم الحرية، وعلاقتهم بالوضع العربي من خلال تسليط الضوء على بعض المفكرين العرب. أما الفصل الخامس فخصص لـ” اجتماعيات الحرية”، موضحا فيه الإهمال الذي طال جسم العلوم الاجتماعية وبالأخص علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم السياسة، لكونها علوم تعبر عن مؤشرات التحرر.
و بناءا على هذا التخطيطـ استطاع عبد الله العروي أن يقدم لنا الملابسات التي تطال مفهوم الحرية، وأن البنية الثقافية تلعب دورا في بناء النموذج الاجتماعي للحرية، مؤكدا على فكرة اهمية العلوم الاجتماعية وانتشار نتائجها في المجتمع، كمؤشر على التحرر. بالإضافة إلى تقعيد الأصول الفلسفية للحرية واقعيا وكذا تنزيله في النقاش السياسي اليومي.
لذا يعد كتاب مفهوم الحرية لعبد الله العروي توطية وتقديم، لكتاب آخر غاية في الأهمية، “مفهوم الدولة” صدرت طبعته الأولى عن المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء في مطلع الثمانينيات، يندرج هذا العمل ضمن سلسلة مفاهيم متعددة (الحرية، العقل، التاريخ)، إذ انصرف فيه إلى تناول مفهوم الدولة على نحو لا يخلو من عمق ورزانة في المضمون الفكري، وتنويع معهود بالنسبة لطرق البحث والمقاربات المنهجية المعتمدة فيه.

من مفهوم الحرية إلى مفهوم الدولة:
أشار العروي في المبحث الأول لمفهوم الدولة لـ “نظرية الدولة في الفكر الغربي الحديث” حيث غاص بنا في النظرية الإيجابية بشأن الدولة في التفكير الغربي، ممثلا لها بالفيلسوف الألماني هيغل (1770 – 1831) الذي أبدع تفكيرا متميزا حول الدولة، إذ يشدد على وجوب خضوع الفرد والمجتمع المدني باعتباره فضاء الاقتصاد والحياة المادية للمبدأ العام للدولة وقوانينها، الأمر الذي يناقض المفهوم الليبرالي التقليدي للدولة كما عبر عنه مثلا جون لوك بوصفها مجرد وسيلة لتأمين السوق وحماية حق الملكية الفردية، بحيث وضع هيغل الأخلاق ضمن دائرة الدولة، ولم يحصرها في الضمير الفردي، جاعلا الدولة فوق الفرد والمجتمع المدني، وفي محور الدولة العربية بين الواقع والطوبى يرى العروي أن عبارة دولة إسلامية غير دقيقة ولا تعبر عن حقيقة الدولة العربية على مر التاريخ الإسلامي (قبل وبعد عهد التنظيمات والحقبة الاستعمارية)، إذ لم توجد إلا في فترة الوحي والإلهام (النبوة)، لأن الدولة الإسلامية – بالتعريف – هي الخلافة.
وفي المحور “الفكر العربي والحاجة إلى نظرية في الدولة” جاءت أطروحة المؤلف الأساسية مفادها أنه إذا كان الفكر الغربي الحديث أفلح في بلورة نظرية حول الدولة وجدت تجسيدها العملي في نموذج الدولة الحديثة الغربية التي أفاض عالم السياسة الألماني ماكس فيبر في جرد عناصرها ومميزاتها، فإن الفكر العربي الإسلامي – بالمقابل – لم يتوصل إلى نظرية واقعية حول الدولة. مقارنة بالفكر الغربي الذي ينظر إلى الدولة كتجسيد عملي للعقل والأخلاق والحرية (عند ميكيافيلي وهيغل).
أحمد طنيش